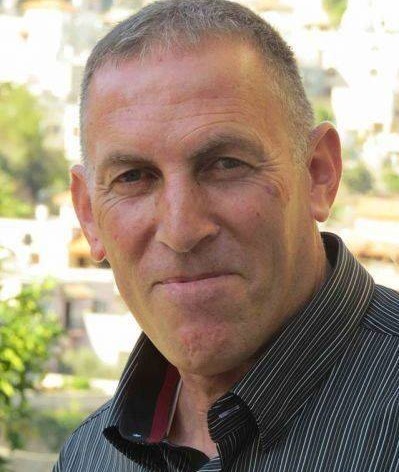رمزية الباب، ودلالات البنية الصوتية قراءة في ثلاثة نصوص شعرية للشاعر سعيد الزبيدي

عباس أمير | العراق
آليتُ أقمعُ إحساسي على مَضَضٍ ولا أطاوعْه، إنْ مرّةً صدقا
المشكلة في المشاعر أن قمعها لا يفضي إلى اختفائها كما تختفي الكلمات من على سطح ورقة بيضاء بعد محوها، بل قد يؤدي قمعها إلى عودها ثانية، وإن بمظهر آخر وتزيٍّ جديد. وعلى قدر تكرار مرّات الظهور والتزيِّ تتكشّف المعاناة، ويشتدّ البحث عن مأوى، وتتضح الخيبات.
وعلى قدر ذلك القمع يتكرّر القرْع على أبواب القلب، وعلى قدر ما يتكرر القرْع يترسخ الشعور الجمالي الذي ينتاب القارئ، وهو بين بينين، بين تعاطفه مع التجربة الإنسانية المريرة التي عاشها الشاعر مرّة، وبين استمتاعه بالتجربة الشعرية التي صنعها ذلك الشاعر مرّة أخرى. وذاك هو قدر الشاعر، الذي ليس له عنه مندوحة ومتّسع إلا المزيد من المشاعر المريرة التي تتشكّل كلِماً جميلا.
كفّي على الباب، ما تنفكُّ ترتدُّ فارفقْ بها، كادَ منها المتنُ ينهدُّ
وقد رأيتَ معي، كم مرّةٍ طرقَتْ كفّي على البابِ، لكنّ الصّدى الردُّ
وما بين الطرق، وإعادة الطرق يصير (الباب) حاضنة دلالية تنوء بقمع مشاعر الإنسان، وقرع تلوينات الشاعر. وعلى عتبة ذلك الباب تربو صور، وتنمو إيقاعات، وتتعدد رؤى، وما بين مصراع الباب وما خلف الباب من آمال وأشواق، مصراع البيت من الشعر وما خلف البيت من مقاصد ومعانِ. وإنما هي، بعد ذاك وهذا، حركة تجول فيها المعاني بصمت الكلمات التي، وإن قالت كثيرا، لكنها لم تقل ما يريد الشاعر أن تقول، وهذا ما دعا الشاعر، وقد أوصد البابدونه أن يتوقف عند ذلك الصمت، قائلا؛
لكنّما الصمتُ أدماني وأوجَعني فدَبَّ فيَّ ارتجافٌ من تجافيها
والمشكلة،هاهنا، الباب، المانع والفاصل بين الشاعر والآخر، ثم ما خلف الباب. فالباب يباعد بينه وبين من يريد، فهو رمز غربته، وما خلف الباب يباعد بينه وبين ذاته، فما خلف الباب رمز اغترابه. وهكذا تتفاقم مشكلة المشاعر حتى لا يجد الشاعر الذي يريد أن يتجاوز تلك السطوح القاسية والقوالب المتيبسة إلى جوّانيّات ما حوله، حلا سوى المزيد من العود إلى الذات الشاعرة بعيدا عن الذات المغتربة التي تصدّعت كثيرا وهي تطرق على باب الآخر، ما يعني مزيدا من الحنين إلى واقع مثالي تحتفظ به الذاكرة بعدّه بديلا مكانيا للواقع المعيش، وتصير المخيلة وسيلة لدركه من جديد؛
لكنّما خيَّلت لي غربتي صُوَراً إن عدْتُ للدار تغريني مغانيها
وأرتمي، وحصيراً كان متّكَئي عليهِ عصراً، وأوراقاً أداريها
وأرقُبُ السّعَفَ المهتزَّ من نَسَمٍ وكم هديلِ حمامٍ، إذْ يناغيها
هل بعدما سقطتْ وهْماً مُخيّلتي كفّي على البابِ، إمّا عادَ حاديها
والنتيجة، محاولة حثيثة لاقتلاع الشاعر نفسه قبالة اقتلاع الباب بكثرة الطرق الذي يُفترض فيه أن يكون داعيا للفتح والترحيب، ولكن اختلال المعايير جعله غير ذلك، فالباب، بكل رمزيته الاجتماعية التي يحتفظ الشاعر بدلالاتها ضمن بيئتها الريفية والقروية، لم يوجد ليردّ الطارق بل ليكرمه ويحتفي به. ولكنه يبقى موصدا، فيبالغ الشاعر في فتحه مستعينا بمخيّلته، فيُفتَح، ولكن الشاعر لم يجد خلفه شيئا يستدعي كل ذلك العناء، وهنا ترقى المشكلة إلى مستوى من التعقيد بالغ، فمشكلة الباب ليست شيئا، الآن،بإزاءالذي خلف الباب؛
كفّي على البابِ أم شوقي الذي سبَقا لم أدْرِ أيّهما، يا صاحبي، طرَقَا
فلهفتي لمْ تدَعْ لي فكرَ منتَظِرٍ حتّى وددْتُ بأنْ لا بابَ مُصطَفقَا
ولا أطيلُ وقوفاً أرتجي خبراً يقولُ؛ من؟ فأريحُ الكفّ منطبِقَا
لكنْ، ويا أسَفاً، طال الوقوفُ بنا وعدْتُ تملؤني الخيباتُ منْخَنِقَا
يا ليتني لم أجئْ أو لمٍ أقفْ أبداً ببابِ مَنْ لم يدعْ للشوقِ مخترقا
وليتني، مرّةً، أجفو بلا سببٍ ولا أراني على الأبوابِ محتَرِقا
وقبالة هذا الباب الرمزي وشفراته الموجعة واحتمالاته المفاجئة هناك باب يفتحه الشاعر على مصراعيه، يفضي بيسر إلى وجدان الشاعر، وهو يجلّي للقارئ ثلاث مثابات شعرية؛
أما الأولى، فهي المثابة التي جعل فيها رديد الطرق مثابة الشاعر وكفّه، فهو لا ينفك يبحث عن باب يُفتح له ليخرجه من ضيق الغربة إلى سعة الألفة، ومن قهرية الفقد والاغتراب إلى حرية المحبة والتواصل. وعند هذه المثابة يتشكّل صوت الغربة من خلال حرف الدال، قافية النصّ.وهو حرف قويّ يُعتمد عليه في المخرج، وهو أكثر حرف دالّ على الشدّة، أما الحاسة التي يستدعيها نطقه فهي حاسة اللمس خاصة، فهو منغلق على نفسه. فإذا ما جاء مشدّدا فقد تأكدت فيه تلك الصفات ودلّ، فضلا عن ذلك، على حركة دائرية تشبه إلى حدّ بعيد حركة النواعير في القرى التي تمتد على ضفاف الأنهر، وأوحى بحركة مطرقة الباب أو عروته، وقد أمسك بها الطارق، يضرب بها معدن القبضة مرة بعد أخرى؛
كفّي على الباب، ما تنفكُّ ترتدُّ فارفقْ بها، كادَ منها المتنُ ينهدُّ
جاءتْ بلهفة مشتاقٍ، تحنُّ إلى مَنْ يمنحُ الآهَ بردًا، حين تشتدُّ
لعلّها تشتهي لُقيا تُسامرُها بما تصرَّمَ من عمْرٍ سينقَدُّ
………….. …………..
كفّي أرادت جوابًا كي تُريحَ بهِ واحرّ قلباهُ، لا ينفكُّ يشتدُّ
وقد رأيتَ معي، كم مرّةٍ طرقَتْ كفّي على البابِ، لكنّ الصّدى الردُّ
وأما المثابة الثانية، فهي مثابة ما بعد الشدّة والانغلاق، وليس بعدها إلا الرخاوة والانفتاح. وبذلك تقضي فيزيائية الحركة الآيلة إلى الضعف بعد الشدّة. وهذا ما يجسّده حرف الهاء الذي اتخذته قافية النص الثاني من نصوص ثلاثي الباب، بعدّه تبيانا لمعنى الهيمنة الذي يكون لصفة تحل محل أخرى بعد خلوّ المحل من حاله وطبيعته حيث تحل السكينة بعد الاضطراب، والقرار بعد الهيجان والجولان، والسكون بعد الحركة، وهذا ما يتضح في؛
ورحُتُ أصفقُ كفّي في مثيلتها ندامةً، كنتُ قبل اليومِ أُخفيها
ورحْتُ أهربُ من أنظار سابلةٍ كي لا يرَوا خيبتي بانتْ معانيها
ولو دريْتُ بما آلَتْ مقاصدُها لأحجمتْ خطوتي ممّا سيأتيها
لكنّما خيَّلت لي غربتي صُوَراً إن عدْتُ للدار تغريني مغانيها
وأرتمي، وحصيراً كان متّكَئي عليهِ عصراً، وأوراقاً أداريها
وعند المثابة الأخيرة، عودٌ إلى الحركة بعد سكون، وإلى القوة بعد ضعف، ولكنها حركة ارتدادية تستعيد بموجبها الذات قوتها وشدّتها وإباءها، بعد تلك الخيبات المتوالية التي أبان عنها التكرار(الدالي) المضعّف، وتأمل فيها وجع المثابة الثانية بهدوئها (الهائي). وإنما هي، وقد أبان عنها حرف القافية (القاف) بكل ماله من صفات الانفجارية وعدم الاستقرار والتقلقل .
دعْني أُلَملِمُ أجزائي وخيبتَها و لا أعود بذاك الدربِ منطلقا
كأنّني بتُّ أستجدي اللقاء هنا أو أنّني صرت شحّاذًا ومرتزِقا
لا خيرَ في أنْ أجُرَّ الذيْل منكسرًا أو أن أخِيطَ على ذلاليَ الحَدَقا
آليتُ أقمعُ إحساسي على مَضَضٍ ولا أطاوعْه، إنْ في مرّةً صدقا
وهكذا، ونحن نتثبّت من تلازم تلك المثابات الثلاث، ما بين طرق الباب، وما خلف الباب، وما بعد الطرق، نخلص إلى أن لكل نص من تلك النصوص فرديّته في تشكيل معنى الغربة، بما يعمل على تحقيق عنصري الانسجام والاتساق بين المثابات الثلاث مرة، وبين شكل كل نصّ ومعناه مرّة أخرى، وبما يكشف عن مظاهر أسلوبية صوتية مائزة، تمكنت من تجلية المعنى الشعري الكائن بين رمزية الباب وغربة الشاعر واغترابه.