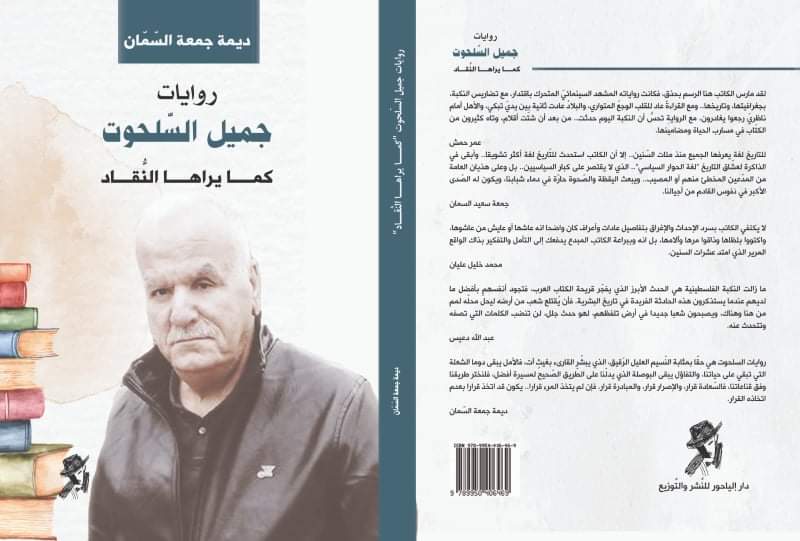الوظيفة التقويمية للنقد
الناقدة والشاعرة ثناء حاج صالح | ألمانيا
أريد في البدء أن أتوجه بالشكر للدكتور ناصر أبو عون على تحفيزه لي لكتابة هذا المقال .
مقدمة
وجدتني وأنا أفكر بالوظيفة التقويمية للنقد أمضي باتجاه مفهوم (نقد النقد)، والذي يتخذ من تحليل القراءات النقدية للنصوص مع إعادة قراءة النصوص المنقودة نفسها في الوقت ذاته موضوعا له، وفعله هذا يهدف إلى تقويم تلك القراءات النقدية وتقييم أدائها وتوصيف مدى كفاءتها في ممارسة النقد التطبيقي.
لقد شاعت مؤخراً في كواليس الأوساط الأدبية وفي مواقع التواصل الاجتماعي القراءات النقدية الانطباعية البحتة، التي يقتصر دور النقد في معظمها على شرح معاني النص من خلال تأويلات اللغة والأسلوب، دون أن يستند (الناقد) – بطبيعة الحال في النقد الانطباعي – في تأويلاته تلك إلى معايير منهجية موضوعية تسبر غور الفعل الإبداعي في النص عبر دَوالِّه ومؤشراته الصحيحة، لتنصفه في عملية التقييم، وتمنحه من ذلك ما يستحقه دون زيادة أو نقصان، كي تنقذ المتلقي وتحصِّنه من أن يقع ضحيةً للتهويم و(الفذلكة اللغوية) التي لا تقدم ولا تؤخر في قراءات دوغماتية تفرض الناص على القارئ بوصفه ملهّماً معصوماً عن الخطأ والتقصير، وتقدم نصَّه بوصفه النص المحكم الذي لا يشوبه خلل أو زلل .
ولو وقعت تلك القراءات تحت عدسة نقد النقد، لانكشفت للعيان أخطاؤها الفادحة في التأويل وفي ممارسة التضليل، ولاتضحت خطورة انتشارها وتسيُّدِها الساحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتأثيرها الفوضوي والعبثي في تشكيل وبناء ذائقة المتلقي الضعيف غير المثقف بالثقافة النقدية المنضبطة، التي تمكِّنه لوحده من كشف زيف تلك القراءات ومغالطاتها.
وإن انتشار مثل هذه القراءات يستند – للأسف الشديد – على فكرة مفادها أنه لا يجب على النقد ( ما بعد الحداثي ) أن يكون معنيِا بكشف ثغرات النص . بل عليه أن يتقبل النص كما هو بوصفه كاملا ومنتهيا، وأيا كانت بنيته الفنية، وأيا كان المستوى الذي وصل إليه من الاختلال المنطقي والتفكك البنيوي والإفلاس المعنوي. حتى أصبحنا نقرأ نصوصا تُسمى (أدبا) وهي لا تعدو كونها سيلانا من الهذيان الكلامي، الذي يأتي بمثله المصابون بأمراض عصبية وعقلية كالشيزوفيرينيا (انفصام الشخصية) والهيستيريا، أوالذين أصابوا من شرب المخدرات ما أوقعهم بالهلوسة، التي يسمعها من ينصتون إليهم، فتثير لديهم الضحك، أو تثير الألم والرثاء لحالهم المزرية.
ثم تُكتَب لهذه النصوص (الملهَمة) قراءاتٌ (نقدية) فتنصِّب أصحابها مناصب المبدعين الأفذاذ ، خاصة وإن نتاجهم الأدبي يغمر الآفاق بسيولته وغزارته. وكيف لا وكتابة النص الواحد لا تستغرق أكثر من بضع دقائق . حتى أن أحد هم إذا راهن على أن يكتب في كل أسبوع ديوانا من ( الشعر) لتمكن بسهولة من الفوز بالرهان. وهو لا يخشى من النقد شيئا، ولا ينتظر منه سوى التصفيق والتمجيد.
إن الموقف الرافض للوظيفة التقويمية للنقد الأدبي من قبل بعض الأدباء ، يدفعنا للتساؤل عن أهمية وجود نقد النقد وأهمية تقويمه لتلك القراءات الناقدة، و يدفعنا للبحث في مدى مصداقية الحاجة التي أدت إلى ظهور نقد النقد ، ليمارس وظيفة التقويم النقدي.
ثم إذا افترضنا جدلاً أن النص الأدبي يتمتع بالحصانة ضد التقويم من قبل النقد التطبيقي، فلماذا لا يتمتع النقد التطبيقي نفسه بهذه الحصانة أمام نقد النقد؟
ولعل هذه التساؤلات ستفضي بنا إلى تساؤلات أخرى تتعلق بنتائج تجريد النقد من وظيفته التقويمية. فهل إذا سلَّمنا جدلا بأن النص الأدبي هو فعلا فوق التقويم والمساءلة في بنيته الفنية، نكون قد سلَّمنا كذلك بعصمته عن الزلل والانحراف في مقولته الأيديولوجية ؟ وأخيرا: ما هو السبب الذي يُمنَح لأجله النص الأدبي -أيا كان مستوى نضجه الفني والإبداعي- كل هذه الحصانة ليكون فوق التقويم والمساءلة من قِبَل النقد؟ مع العلم أن الوظيفة التقويمية للنقد الأدبي – عند الاعتراف بأهميتها – تتجاوز تمحيص وتقويم أدوات النص الأدبي المنقود ليمتد تأثيرها إلى تقويم الأفكار المغلوطة التي قد يعمل النص على بثها ونشرها أو الترويج لها. كما يمتد إلى تقويم الذائقة الأدبية والجمالية العامة التي قد تعمل بعض موجات التيارات الفنية الفلسفية السلبية ( كالعدمية والعبثية وغيرها ) في بعض المراحل من التاريخ على حرفها عن طبيعتها المعتدلة أوتشويهها .وخاصة في ظل ما يُسمى ( بالغزو الثقافي) الموجَّه الذي يستهدف عبر التأثير الانفعالي في الذائقة العامة، تغيير وتشويه القيم الأخلاقية والدينية عند الشعوب الضعيفة، التي تستسلم له لعدم استعدادها لمواجهته كونها تعرضت للغِشِّ في تبني فكرة (التقبل المطلق لكل شيء) كأمر واجب وضروري لصون حريات الأفراد، وأهمها حرية التعبير عن الرأي،وإلاَّ فإن الذائقة العامة للأمة ستوصم بالتخلف أوعدم الانفتاح.
إن أسهل وأنجح طرائق الغزو الثقافي لتمرير وتسويق الأيديولوجيات التي تنخر في روح هذه الأمة هي أن يتم ذلك عبر وسائل الإعلام بما تتضمنه من الآداب والفنون، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي فإن لم يقم الناقد الذي يعي دوره بمهمة مواجهة هذا الغزو، عبر ممارسة وظيفته التقويمية، ومن خلال كشفه المستمر والدؤوب لتلك الدسائس الأيديولوجية في النصوص الأدبية،والأعمال الفنية، وتعريتها، وتبيين مدى انحرافها عن الحقيقة التاريخية، وكيفية تأثيرها ، وأين تكمن السموم والعوامل الممرضة فيها ، فمن الذي سيقوم بهذه المهمة ؟
هل الناقد مصلح اجتماعي ؟
الناقد ليس مصلحاً اجتماعياً بالتأكيد. ولكن الثقافة التي يحتاجها المصلح الاجتماعي لكي يمارس مهمته الإصلاحية تعتمد على جهد الناقد في التمييز بين ما هو صالح ورديء من الأفكار والمفاهيم الأخلاقية في النص، وبين ما هو أصيل ومزيف من الاحتياجات التي يثيرها مروجو البضائع الأيديولوجية في (الأسواق) التي يحاولون السيطرة عليها لتكون تابعة لهم، وغير قادرة على الاستقلال عنهم، بلهَ على مزاحمتهم، وهي وسائل الإعلام الثقافي بأشكالها وأنواعها كافة .
النقد أيضا وبأشكاله كافة، وفي مجالاته المتنوعة كافة ، في الفكر والأدب والفن والسياسة والاقتصاد …إلخ ،هو صاحب القول الفصل في التقييم والتمييز والتدقيق في النص .وبالرجوع إلى بيانات النقد الصحيح فقط والاعتمادعليها، يمكن التقويم ويمكن التصحيح والإصلاح، أيا كان مجال الإصلاح.
ولكننا هنا نتحدث عن النقد الأدبي ومهمته التقويمية، التي تترك أثرها المباشر في مسارات تطور التجارب الإبداعية عند أصحابها. والتي نلمس في الواقع تأثيرها هذا عند الأدباء، وكثير منهم يعترفون بدور النقد وفضله عليهم في تحسين أدائهم التعبيري وصقل أدواتهم الفنية وبلورة تجاربهم الإبداعية .
إن الناص أوالأديب الذي لا يهتم بردود أفعال النقاد تجاه نصوصه الأدبية قد لا يستطيع أن يكتشف نقاط الضعف الحقيقية في تجربته الإبداعية، كي يتغلب عليها ويتلافاها. كما لا يستطيع أن يكتشف بوضوح ودقة مكامن الإبداع والتميُّز في موهبته الخاصة، كي يعمل على صقلها وإبرازها.وهو محتاج نفسياً إلى الاطلاع على رد فعل المتلقي تجاه نصوصه، ويهمه كذلك تقييم النقد الأدبي المنهجي لأدائه. وكل ذلك يساهم في نمو القدرة الشخصية للأديب نفسه على ممارسة النقد الذاتي وحُسن توجيه دفَّة القيادة في التجربة الإبداعية.
وجهان لعملة واحدة
الناقد الذي يرى أنه مضطر لقبول النص دون التفكير بإبداء أي اعتراض عليه، لتبنيه فكرة موت الناص الذي لن يستفيد من ملاحظات النقد بعد موته ، يكون عاجزا عن تقييم النص تقييما حقيقيا. فشرط التقييم أن يكون الناقد مستقلاً ذهنياً ومتحرراَ في قراءته النقدية من الإملاءات وفكرة موت الناص هي في حقيقتها إملاء يشل أدوات الناقد ويعيقها عن المضي بالتحليل النقدي إلى آخر منهتاه وغايته. فالناص (في رأيي ) يجب أن يكون حيَّا في مساحة النص الموازي واعتباراته ، وطالما أن اسم الناص موجود في النص الموازي فالناص موجود وحي ، وينبغي على الناقد أن يحاوره عند قراءة نصه بأسلوب غير مباشر، سواء من موقع البيئة الداخلية للنص ومن بيئته الخارجية في النص الموازي.
هذا الاستقلال الذهني عن الإملاءات والقيود التي تحد من صلاحيات الناقد هو حقا ما يؤهل الناقد نفسياً وذهنياً لرؤية وقراءة سلبيات النص وإيجابياته على حد سواء. وهذا ما يمكِّنه من اكتشاف الثغرات -إن وجِدت- فضلا عن اكتشاف نبوات الإبداع المرتفع في النص. فيكون تقييمه للنص حقيقيا وموضوعيا. وويكون له أن يقول مثلا: “إن النص قد نجح في تقديم رؤيا معينة أو إثارة شعور معين عند القارئ أو نجح في تكثيف اللغة . لكنه فشل في ابتكار صور شعرية جديدة ، أو فشل في الإمساك بخيط الأفكار لعرضها في سياق متنام يخدم وجود حبكة معينة، وهكذا …”
وكما هو واضح مع هذا المثال، فإن هذه التقييم يجب أن يحدد نقاطاً معينة، يمثل بعضها جوانب إيجابية، فيما يمثل بعضها الآخر ثغراتٍ ونقاط ضعف . فإذا ما التزم النقد بهذا التقييم يكون قد مارس (التقويم ) ممارسة تلقائية وغير مباشرة؛ وذلك لأن تحديد الثغرات يرتبط بالتلميح إلى إيجاد خيارات بديلة محددة تصلح لسد تلك الثغرات وهكذا يكون النقد قد وفَّرللناص المادة البديلة التي تضمن تقويم ثغرات النص وتلافيها.
أسباب رفض الوظيفة التقويمية للنقد الأدبي
إن رفض الوظيفة التقويمية للنقد الأدبي يرجع إلى سببين :
أولا – رفض الوصاية على الإبداع
من الطبيعي أن يرفض المبدعون الوصاية التي قد يوحي به مفهوم (التقويم) في النقد . لكن حقيقة الأمر أن الدور التقويمي للنقد لا يمثل أية وصاية على الإبداع؛ لأنه لا يتدخل في إبداع النص وإنشائه ، والأمر ببساطة؛ أن الناقد لا يملك سلطة إلزام الناص باعتناق وجهة نظره البديلة عند تقويم نصه، ولا شيء يمنع الناص من أن يضرب بوجهة نظر الناقد التقويمية عرض الحائط.
كل ما في الأمر أن الناص والناقد كليهما متعادلان في حق امتلاك وجهة نظر مختلفة عن الآخر ،وهما يمتلكان معا حق التعبيرعنها دون قيود. فلماذا نقوم بإلزام الناقد وقسره على أن يتبنى وجهة نظرالناص في نصه، حتى ولو لم يكن مقتنعا بها، عبر سلبه صلاحية الاعتراض على النص، ومنعه من أداء وظيفة التقويم إلى جانب التقييم ؟
إن للناص الحق كله في أن يكتب دون وصاية، وإن للناقد الحق كله في أن يمارس النقد كاملا. ثم يحق للقارئ بعد ذلك أن يقرأ وجهة نظر كل منهما وأن يختار ما يشاء ويتبنى ما يشاء مما قدمه كل منهما.أما أن نعطي للمبدع وحده حق التعبير دون قيود، ثم نضع للناقد قيودا وحدودا نمنعه من تجاوزها عند قراءة النص، خوفا وحذرا من أن يقف في جبهة مضادة للناص ، فلا شك أننا بفعلنا هذا نصيغ معادلة خاطئة.
ثانيا – رفض إجراء التقويم المدرسي على النص الناضج
إن النظرة إلى الوظيفة التقويمية للنقد الأدبي على أنها إجراء مدرسي تربوي، ويجب أن يقتصر في تطبيقه على المراحل الأولى فقط من عمر التجارب الإبداعية عند الأدباء، وقصره خصوصا على نصوص الأدباء الشباب الذين يُتَوقع منهم الاحتياج للمراقبة والمتابعة والتوجيه، دون أن يستمر ذلك عند تناول النصوص الناضجة إبداعيا في المراحل المتقدمة من عمر التجربة الإبداعية ، هذه النظرة كثيرا ما تكون صحيحة، إلا أن الالتزام بها يعني التسليم بها يقتضي التسليم بكمال النص الناضج إبداعيا واستعصائه على التقويم.فهل يمكننا التسليم بهذا نظريا؟
الأمر في مسألة مستوى النضج الفني في النص الإبداعي. أن هذا المستوى يمكن أن يتفاوت عند الناص نفسه وحتى بعد ان يقطع شوطا طويلا من التجربة الإبداعية.. لأن الإبداع الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون تجريبا. والتجريب لا يمكن أن يكون محسوم النتيجة . وفي كل نص جديد فإن الكاتب أو الشاعر يخوض المغامرة من جديدة في أثناء تجلي النص على الورق. وليس هذا التفاوت ممكنا فقط على مستوى المقارنة بين النصوص التابعة للناص نفسه، بل هو ممكن أيضا على مستوى القراءة النقدية المقارنة بين النصوص المختلفة لأدباء وشعراء مختلفين. فإذا كانت القراءة المقارنة تحتم علينا التطرق بالنقد إلى تلك التفاوتات والفروقات عند تقييم النصوص، فإنه من الأولى لنا الاعتراف بحق النقد في تحديد تلك الفروقات وتبيين ما فيها من تمايزات تجعلها متفاوتة القيمة سلبيا وإيجابيا للاستدلال على مقومات التقييم والتي ستطرح الخيارات البديلة عبر المقارنة النقدية لتؤدي بطريقة غيرمباشرة وظيفة التقويم.