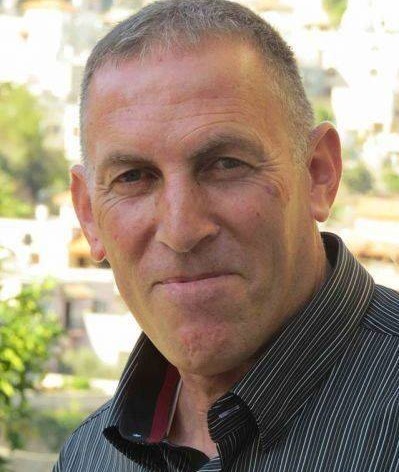قراءة في ديوان ” مرايا الورد ” للشاعر العراقي وليد الزبيدي

نجاح إبراهيم | ناقدة من سوريا
مراياك توقٌ لأبّهة القصيدة
هاتها مراياك!
تغسلُ الوجوهَ بالسّطوع والحروف ، وندى الورد.
هاتها مراياك؛ ليست إلاّ انعكاساً لخطايا وعيوب وانكسارات، فهذا البلد الذي أمامك ليس سوى قارب و..:
” القارب لا يخلو من ثقب
فقد عكست عليه مرآة:
خطايانا
ثقوبنا
عيوننا
انكسارنا..”
وأنت أيّها الشاعر الحزين، الحزين إلى أبعد نقطة فيك، تحاولُ أن تسدّ الثقبَ بقصيدة تقدّها من نبضك وصبرك، لتمضي السفين إلى الضفة الأخرى حيث الجمّار في النخل يكون شافياً ورطباً.. لتنهضَ ألفُ أغنية لوطنٍ آنى جئته يتلوّى ألماً ، وللإنسان الذي تأمل أن يكون ، وللآتي ، الآتي الذي تبتغيه نوروزاً للأعياد.
في مراياك : يتوقُ ما في الرّوح من توقٍ لأبّهة القصائد وهي تتناسجُ من خيوطِ حروفك ، نغطي بها مسامنا الآيل للتجفاف والانكماش ، نشربها تراتيلاً حتى الثمالة ولا نرتوي. ولن ننكر حيرتنا أمام طرق انسانيتك التي تفضي على الرّغم من الضّباب والقرّ والقحط ، إلى الفجر الطليق.
والفجر المتدفق يطلعُ من مرايا وردك أيّها الشّاعر!
لنحيا كثيراً، نجربَ طعم الحياة في كلّ قصيدة..
وللحياة طعوم كثيرة.
الشاعر “وليد الزبيدي” ، في ديوانه ” مرايا الورد” يجعلنا نغذّ السير طويلاً عبر خرابات الحروب المتعاقبة، ويباس النفوس المتآكلة، وتضاريس المنافي ، والحرائق، والدّخان، والخيانة والذنوب..ليكشف في آخر المطاف الستارة عن شموس يضعها بين أيدينا ، تعكسها مراياه بألوانٍ من فرح، ورغبة أكيدة في الحياة.
وهذه كما قلت لا يمكن طويها بسرعة ، فالديوان يعجّ بالوجع والغصص المتأتية من بلدٍ ما يزال يرشح منذ أزلٍ أحزانه، وما قدر نهرا الفرات ودجلة أن يطهراه مما علق به ، ولا أن يوقفا نشيج الدّم المتهادي في الأرجاء ، ولا أعاصير الليل الجائع إلى الرّعب والفُرقة واشتهاء المنافي حلماً لا ينام.
نهران رجونا على أقل تقديرٍ أن يخبئا ما في البلاد في أعماقهما من آلام وفجائع، لكنهما لم يستطيعا إلاّ أن يُظهرا كلّ هذا على سطحيهما، من خلال مرايا الشّاعر و بطريقة راقية وشافّة كالتماعات قطرات ندى على بتلة وردة؛ إذ بأسلوبه المعهود يصبُّ قصائده المتموّجة بالمعاناة ، المقيمة في شرايينه، مُبرزاً إياها بإحساسٍ مريرٍ، نقيّ ، متأملاً تجاوز هذا المرّ إلى الحلم:
” في مربع يفوق أفق الزمان
يفوق تكعيبية البحر واللون
ينحت في رمل دجلة
في صخر(النمرود)
تتفتحُ رياضٌ بين كفيه
وقصور تفتحُ أبوابها لمخيلتها
التي توهّجت مع فتيلِ فانوس..”
الشاعر ” وليد الزبيدي” حين يقبضُ على فكرةٍ من الحياة، لا تخلو من الألم والمعاناة، فإنّه يعكسها عبر قصيدته / مرآته، شعراً مغايراً ، يموجُ في سطوح مراياه بيسر وألق عفويٍّ ، بعيد عن الافتعال والتكلف الممجوج. فالقصيدة تأتي كما لو أن ماء يتبارق تحت أشعة الشمس، يبهر الأعين على الرّغم من قوّة الصياغة ، ومتانة السّبك ، ودقة الرّمز وعمق الدلالة، فالعبارات قد نجدها بسيطة التعبير ، سلسة ، بيد أنها تخفي وراءها ما تخفيه الأكمة ، فيتلقفها المتلقي حسب ثقافته، يأخذ منها ما يريد ، وهذا يدل بلا ريب على موهبة الشاعر وإبداعه اللافت:
” لو زمجرت كلُّ المنافي
أو تطوف بك البلد
لو ناحت الأرجاء
تصرخ وا..ولد
والآن وحدك في الخراب ولا احد..”
إنّ من يقرأ قصيدة الشّاعر يشتمّ رائحة ثقافات مطوية فيها وآثار خطى شعراء أثروا في شعريتها، لما فيها من أبعاد دلالية وجمالية ، فالقصيدة تطلّ على بقعة خضراء تهفو النفس لتلامس عشبها ، الذي نبت من حساسية مفرطة أسهمت في صياغة الحالة الشعورية ، ليترامح أملٌ في جراح الواقع ، يدعو النفس المختنقة إلى السكينة والحبّ:
” جدائلك
التي تعلمت
الطيران
على كتفيك
اختارت غصناً آخر ..”
لدى الشاعر الزبيدي احساس جمالي عارم في كلّ نصِّ من نصوصه، هذا الإحساس نتجَ عن رؤاه الجمالية من خلال استجراره للغة رشيقة ، يشكّل منها انبعاثاً جمالياً، فالشاعر اختار كلماته لجمله بمهارة، ليكون لها وقع عند المتلقي تؤثر بعلوها الفنّي التأثيري فيه، مشكلة عنصر المنفعة والمفاجأة والإثارة النصية ، إذ نجدها انسكبت بشكلٍ لافت ولائقٍ وواهبٍ فنياً، ومن هنا نستشفُّ أنّ المبدع لا يستمدّ رؤيته الجمالية من فراغ- كما قال الناقد عصام شرتح- وإنما من حصيلة خبرات وتجارب ومعارف وجودية وكونية سابقة وعميقة في الآن ذاته. تذهبُ عبر منتجه الجمالي لتتغلغل إلى مشاعر واحاسيس المتلقي ليس لاستساغتها فحسب وإنما ليتفاعل معها:
” المعابد تغلق سماواتها
حينما يحلق صوتك في عوالم
موسيقى (الأورغن)
تحتفي الطقوس
بإشارات عينيك
وارتجاف أناملك
ورعد شفتيك..”
ونحن نمضي في مواكبة قصائد الديوان نلمح في بعضها عتاباً ملفحاً بالمودّة، إذ يعاتب الوطن برقة، يندهش للذي يحصل منه وفيه ، فيصطدم ليقول حتى أنت يا … ونستذكر أنطونيو الذي خانه بروتوس ، ودفعه إلى الموت ، كان من الممكن والجائز أن يخونه الكلّ بلا استثناء إلاّ بروتوس الصديق الصدوق. وكذلك الشاعر يستغرب كيف خانه وطن يفكر في قتله ودفنه حتى صيّره مندهشاً ومعاتباً:
” حتى أنت يا وطني!
ستقتلني
وتدفنني
بلا كفن..”
لا يخفى على المتلقي النضجَ في القصائد ، والذي ينمّ عن تجربة الشاعر الرّافلة بالعطاءات ، ووعيه لما يجري حوله وكيفية مدّ جسوره لإنقاذ ما يمكن انقاذه من خلال الكلمة الحاملة مواسمها في بذورها.
ها هو يتساءلُ كيف تنبتُ للناس أجنحةٌ ليشرعوا بالطيران ،إذ يراهم ضائعين، خائفين، نائمين، يسرقهم المسؤولون ، والليل الذي يحدق بهم سيطول، والصبح عسير مولده ، بيد أن مجرد التفكير بالطيران وليس المشي أو الرّكض ، إنّما يدلّ على إجابات قابلة للمثول بين أيدي من اتّهم بالضياع والخوف:
” وسمائي حريق ودخان
والغول يطير كذا الجان
فنتوه بطور وسينين
ورؤوس يأكلها الطير
كيف نطير؟”
فحين طرح الشاعر تلكم الأسئلة ، ليس عجزاً كما يظنُّ البعض، وإنّما رسماً لطريق أفضل ممكن سلكها، ولغد ناضح بالحياة النبيلة. فالقاربُ الذي تاه بالناس وسط الصراخ وأمواج الخطيئة ، إنّما هو برأيه:
” خريطة
نحو
نصرٍ
وفتح قريب.”
” مرايا الورد” سلّة من المشاعر الفياضة ، والحرقة التي تذيب الكبد على خيانات واسعة رصدها الشاعر من خلال تجربة ملأى بالغُصص والجراح والألم ولنقل الأمل.
سلة على الرّغم مما تحتويه ، بيد أنها تغلف كلّ هذا بالجمال ، واللغة الخاصّة به، يصقلها من أجل شموس تنتظر بهاءات المرايا وعبق الورد:
” الوردة التي تمسك
أطراف أناملك
تضيء اللحظة.”
إنّ القصائد في ديوان ” مرايا الورد” تخاتلُ المتلقي، يظنُّ أنها رافلة بالعبق والورد مرّ الشاعر ذات شفق فقطفها بيسر، وكأنّ بلاده لا منغص فيها أبداً، مجرد قطعة من الجنة لا همّ ولا غمّ، وما إن يقرأ القصيدة تلو الأخرى حتى يُطعنُ بألفِ وجعٍ، ويتلفع بغلالات من سواد وغُصص وخراب.
ذلك هو العراق، خلق مسرحاً لأحداث لا يغيب عنها الحزن ولا الدم؛ العراق الذي ما فتئ يتطهر، ويدفع الثمن غالياً من ذنوب البشرية.
فآنى لأيّ شاعر عراقي، أن يكتب بمداد الفرح الخالص، أو الورد دون ذكر الشوك؟!
فما بالك بشاعر مرهف كوليد الزبيدي، أن يفعل؟
وكيف لمراياه ألاّ تكون مخاتلة لتشدّ القارئ إلى سطوعها؟!
على الرّغم من سوداوية ما في القصائد، فإنّ الشاعر رغب أن يطمسها بورودٍ نثرها في مراياه. أراد من كلّ قلبه المدمّى أن يهدمها عبر صراعاته ، ومراهنته عليها ، عبر فضاءات تجلبُ التحدي والنصر . استند في هذا على الوهج الذي انبعث من المرايا وألق القصائد وانزياحاتها، ومعماريتها واتكائها على بنية تتنامى من بُعد دلالي ، ما يني يفتحُ آفاقاً للتأويل.