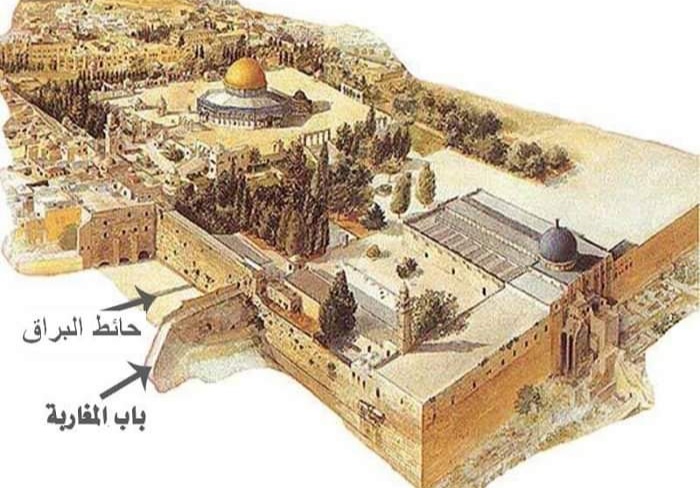هل كنا نحتاج إلى وباء مثل الـ(كورونا) لندركَ قيمة الحياة التي نعيشها؟

محمد المحسن | تونس
تخطر ببالي تلك القصة عن امرأتين كانتا في السجن معاً وفي ذات الغرفة وعند خروجهما سألهما أحد الحراس: كنت أراكما تقفان خلف النوافذ ليلاً،ماذا كنتما تراقبان؟
قالت الأولى: لم أكن أرى إلا أرضاً موحلة.بينما قالت الثانية : لم تخلو السماء ليلةً من النجوم
ما أريد أن أقول؟
إأردت القول أنّ الوقت يمضي ولا ينتظرنا،فإما أن نتقيد بالحجر المنزلي للحفاظ على سلامتنا وذلك سيعطيننا فسحة لا بأس بها لممارسة هواياتنا،كقراءة الروايات مثلاً أو ممارسة الرياضة داخل المنزل،أوالالتفات إلى بعض المسؤوليات والأعمال المؤجلة (قد حان وقتها الآن)،ثم إن الطقس الحاليّ ملائم جداً لزراعة نباتات الزينة المنزلية والعناية بها،تلك الهواية التي تعيش بداخلي واستيقظت الآن ..
أمور كثيرة يمكننا فعلها في الوقت الحالي حتى نجعل من الحجر المنزلي وقتاً محبباً نعيشه بطمأنينة وسلام و نستثمره بما هو مفيد.
قيمة الوقت في الحياة الأسرية :
أمس اتصلتُ بصديقي لأطمئن عنه في ظل هذه الظروف التي تعيشها الكرة الأرضية. قال: الآن عرفت أنّني فقدت الكثير من اللحظات السعيدة.
سألته : هل ينبع كلامك هذا عن خوف من الموت،أجاب: هنالك خوف لا أخفي ذلك،لكن ما قصدته أنني بفضل البقاء في المنزل، عرفت معنى الحياة الأسريّة، حيث أصبحت أمضي كل الوقت مع والديّ، بينما لم يكن يتسنى لي ذلك في الماضي بسبب العمل خارج المنزل والذي يستهلك معظم وقتي، أنا حزين جداً بسبب ما تتعرض له بلادي لكنني سعيد بالوقت الذي أقضيه مع أسرتي، ذلك الوقت الذي لم أكن أقدّره سابقاً ثم قال ساخرا : علي أن أشكر كورونا لأنه نبهني أن هناك ما يستحق أن نعيش لأجله.”
وإذن؟
يعيش العالم اليوم إذا،تجربة تاريخية تكاد تكون تجسيدًا سينمائيًا لرواية شهيرة تتحدث عن عالم ما بعد انتشار فيروس قاتل،يصيب العالم بأسره بهلع ٍوفزعٍ ورعبٍ لا يمكن وصفه بأي وصف كان.لقد جعل فيروس “كورونا (كوفيد-19)” العالم يصير تحقيقًا حيًّا لما تخيّله مبدعون كُثر، أمثال جيوفاني بوكاتشيو وجاك لندن وألبير كامو وجوزيه سراماغو وغيرهم…حيث تشتد كثافة الأنانية -وحتى التضامن بشكل مقابل-وتتقوى غريزة البقاء وحتى الصراع من أجله كلما اقتربنا من الموت.
ما يجعلنا نتحقق من أن “الشر ليس مسألة الفرد الواحد،إنه مسألةٌ عامةٌ تخص البشرية كاملة،فهو متجذّر في الإنسان وعنصر من عناصر تطوره وتكونّه وحتى تحضّره..فما أن يصير البشر عرضةً للموت والهلاك حتى يميلوا إلى إبراز غريزتهم من أجل البقاء بكل ما أتوه من قوة. وكلما اقتربنا من الموت اشتدّت رغبتنا في الحياة،واستعددنا كل الاستعداد للصراع من أجل العيش.
ومن ثم فحالة من الديستوبيا أو حالة من اللانظام،هي ما يصاحب حالة الهلع والفزع والميل الشديد نحو البقاء،حيث تتحول كل المدن إلى خلاء،أراضٍ خاوية من البشر الذي يتحصنون بما أتوه من أبواب هروبًا من الموت الذي يطاردهم خارج البيوت،فتصبح عملية “الخروج من البيت مغامرةً خطيرة”،كما عبّر كافكا.بل إن القيام من السرير لمخاطرة غير محسوبة العواقب. هذا ما يجسده لنا الأدب عبر تلك القصص والروايات التي تناولت كل تلك السيناريوهات المحتملة،فيكفينا أن نقلب صفحات “1984” لجورج أورويل أو “البرتقالة الأوتوماتيكية” لأنتوني برجس أو غيرهما من الروايات..حتى نتحسّس ما يمكن أن تقع فيه البشرية بعد الدخول في حالة “الديستوبيا” حيث تسود الأنظمة الفاشية أو عالم ما بعد الخراب،حيث لا يسود أي شكل من أشكال النظام؛ لهذا قد تكون الرواية بكل ما تحمل من خيال وتخيل منفذنا الوحيد للنجاة،أن نضع نصب أعيننا كل تلك الأحداث المتخيلة لتجاوزها -واستبعاد هذا السيناريو- أو على الأقل معرفة كيف تداركها وإصلاح عواقبها.
الأدب..بلسم للروح حين تتشظى :
علاجنا من كل عبثية العالم والمستقبل المجهول هو الأدب،بل من “التخيل” من حيث إنه،معرفة الصورة كما يقول جون بول سارتر،وإنه ليأتي من الإدراك.
ويضيف بأنه “الإدراك المطبق على الانطباع المادي الناتج في المخ،هو الذي يعطينا وعيًا بالصورة.ولكن الصورة ليست موضوعة أمام الوعي كموضوع جديد للمعرفة،بالرغم من اتسامها بالواقعية الجسمية،فذلك يمضي إلى ما لانهاية بإمكان العلاقة بين الوعي وموضوعاته. فللصورة تلك الصفة الغريبة،وهي القدرة على تسبيب أفعال النفس،فحركات المخ التي علتها الموضوعات الخارجية،وإن كانت لا تتضمن شبهها،إلا أنها توقظ في النفس أفكاراً،والأفكار لا تأتي من الحركات،بل هي فطرية في الإنسان”.
وإذن؟
إذا،فإن ما يقوم به هؤلاء الأدباء المتنبّؤون هو مجرد تحريك فطرتهم الإنسانية،لمواجهة المجهول.
إن التخيّل سلاحهم الفعّال لذلك.فما يقوم به المبدع هو تحوير الخيالي إلى واقعي،والواقعي إلى خيالي،مكثفًا دلالاته ورموزه لبناء عالم ما سيأتي.
يعمل الأديب إذن،عمل “الكهنة في المعابد”وهم يحاولون التنبؤ بما تخبّئه السماء من مستقبل.وها نحن نجد أنفسنا أمام ما تناوله كامو في روايته “الطاعون”،حيث لا يتعلق الأمر بالطاعون فقط،والحالة هنا الكورونا،بل بالعزلة والحصار الذي سيشتكي الناس منه.
فالحصار والعزلة لا يقلان خطرًا عن الوباء المتفشي.ومع الشكوى يكبر الشك من كون الأمر مجرد مؤامرة،فيقع الكل في صراع بين عزل أنفسهم وبين الخروج للتسكع،لأن الأمر مجرد في نظرهم مؤامرة لحصرهم وعزلهم..!!
أليس شعار النجاة –بالأمس-من الوباء المستجد هو “الزموا بيوتكم”؟!…
بعد عزلهم يصابون بـ”العمى”،مُنقادين نحو الخراب،باحثين عن أي مصدر للطعام والغذاء غير مهتمين إلا بأنفسهم وبجماعتهم،مستعدين كل الاستعداد “للقتل” من أجل البقاء والإبقاء على الجماعة التي يستشعرون الأمان داخلها.
تسعى جلّ روايات الوباء وعالم المدن ما بعد الفوضى أن ترسم لنا حياة “الإنسان الأخير” (أستحضر هنا رواية ماري شيلي)، مقابل “الإنسان الأول” ذلك الإنسان الذي يخرج من صلبه العالم. “الإنسان الأخير” يتحرّك في الطريق حاملًا على ظهره الماضي والمستقبل،مواجهًا كل الصعاب،باحثًا عن ملاذٍ آمن يزرع فيه البذرة ليخرج العالم كالعنقاء من رماده. إنه بالتالي يحمل هموم وخلاص العالم كاملًا.ولكن ألا يمكن أن يكون “الإنسان الأول” في الأسطورة هو “إنسان أخير” في عالم سابق؟
على سبيل الخاتمة:
يستطيع الأديب أن يخلق عوالم تتقاطع من التجربة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها، بل إن كل نصٍّ إبداعي تخيّلي أو واقعي، بل مهما كان النص واقعيًا فهو تخلي، يحمل في طياته دلالات قابلة للتأويل وإعادة التأويل بشكلٍ مضاعف…ما يجعل كل عمل سردي تخيلي قابلًا أن يتحقق أو تتحقق أجزاء منه على أرض الواقع،لأنه يحمل في طيّاته خبراتٍ وتجارب إنسانية ومعيشية.فلا ينفصل الواقعي عن المتخيل،وأما النص الإبداعي فهو حاصل ما خبره وجرّبه المبدع وما راكمته الإنسانية عبر تاريخيها من أحداث وأفكار ورؤى فلسفية واجتماعية…
وإلى جانب كون المبدع ذاكرة لمجتمعه وحتى للعالم، فهو مرآة لهما أيضًا،مرآة تنعكس عليها كل تلك الرؤى والأفكار على امتداد الخط الزمني بدءاً من الماضي،ومرورًا بالحاضر،وصولًا إلى المستقبل البعيد والمجهول.
هل بقي لدي ما أضيف؟
لربما تجد حكومات العالم اليوم نفسها ملزمة بإعادة فتح كل صفحات تلك الروايات والأعمال السردية،كي تبحث عن الحل الخفيّ في طياتها،وتعيد ترتيب علاقة السياسي بالأدبي والواقعي بالمتخيل.فكل تلك الروايات تحاول أن تعيدنا إلى الحالة الإنسانية،أن تجعل النار المتأجّجة فينا مشتعلة إلى الأبد.وأن تبعد عن كل تلك الإيديولوجيات التي تضلّل الفرد وتحيده عن “الطريق”. لهذا ينتصر كل هؤلاء المبدعون للإنسان،لا لشيء آخر.
وبما أن الإنسان قد تخلّص من أساطيره القديمة،أو يكاد،فهو اليوم يخلق أساطير جديدة تقوده إلى النجاة في هذا العالم المعاصر،أساطير نعرف كتابها ونعرف أين كتبت ومتى كتبت، أساطير نسميها “روايات”… لكنها قابلة للتحقق من حيث إنها قادمة من ذات مبدعة وإنسانة،لا من عوالم ميتافيزيقية تتجاوز الواقع والـمـُعاش.وبالتالي تغدو كل الشخوص البطلة في تلك الروايات شخوصًا أسطورية تحمل على أكتافها صخور سيزيف،بعدما تحدث كل تلك المصائب حاملة لنا “خريطة الخلاص في الطريق الطويل للمستقبل المجهول والمتقلب”، لنفتح النوافذ رافعين رؤوسنا إلى الأعالي لرؤية أشعة الشمس والتخلّص من الوباء والعمى..
في النهاية يمكن القول،إنه ما من شك في أن ثمة أعمالا أدبية في طور التحضير الآن،بشأن ما نواجهه في الوقت الحاضر،ما يحدو بنا للتساؤل عن الطريقة التي سيصوّر بها الكُتّاب في الأعوام المقبلة الوباء الحالي،وكيف سيوثقون ما شهدته الفترة الراهنة من تنامٍ كبير لروح التضامن بين أفراد المجتمع وبعضهم بعضا في مختلف دول العالم، وكيف سيرصدون البطولات التي يبديها الآن عدد لا حصر له ممن يعيشون بيننا..(الجيش الأبيض..الإعلام..على سبيل الذكر لا الحصر ..)
كل هذه أسئلة يتعين علينا التفكير فيها مليا،بالتزامن مع تخصيصنا الآن وقتا أكبر للقراءة والاطلاع،وتحضيرنا أنفسنا في الوقت ذاته،لرؤية العالم الجديد،الذي سيبزغ في أعقاب انتهاء محنتنا الحالية.