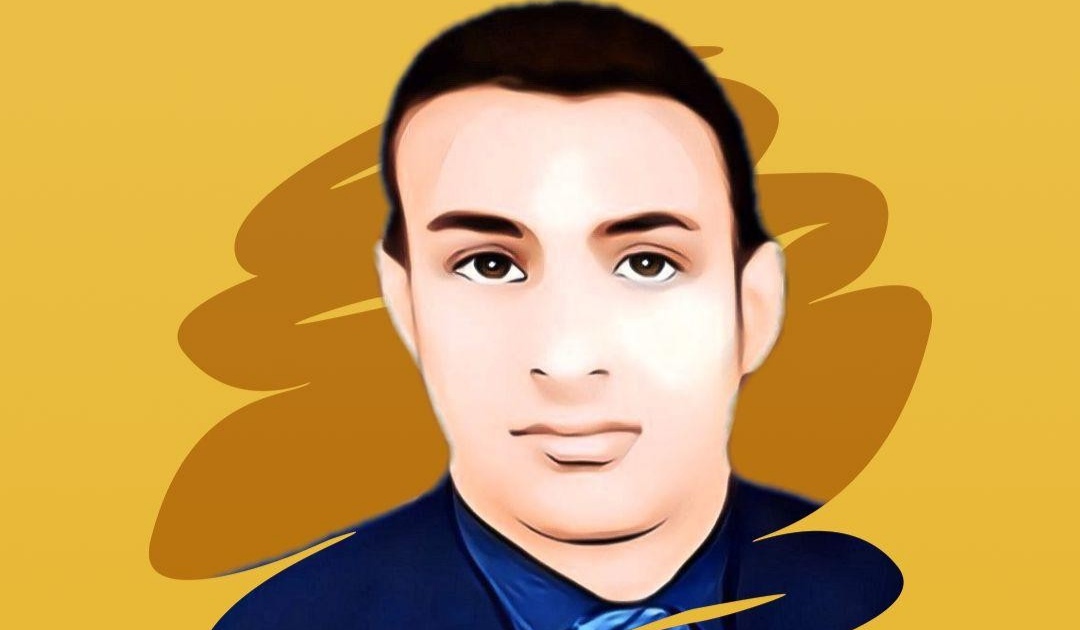ميغيل دي سيرفانتيس يحل ضيفا على أبي الطيب المتنبي

منتصر لوكيلي | المغرب

خلال زيارتي الأخيرة لمدينة فاس، كنت على موعد مع مدير معهد سيرفانتيس الإسباني الذي سبق له وأن زارني في مكتبي بمدينة وجدة، ورأيت فيه رجلا لطيفا دمث الأخلاق ودودا.. وقد انتبهت منذ مدة إلى كون المعهد المذكور قد غادر مقره السابق بشارع السلاوي ليستقر غير بعيد عن شارع الجيش الملكي. وما إن أجلت نظري في الزقاق الجديد الذي حط به سيرفانتيس الرحال، حتى انتابني شعور يمزج الدهشة بالغبطة والفرح، فهذا الشارع “الثانوي نسبيا” يحمل اسم أعظم شاعر عربي على الإطلاق، ويضم فيما يضمه بناية تحمل اسم أعظم كتاب الأدب الإسباني.

لم تكن المرة الأولى التي أصادف فيها طيف سيرفانتيس، فقد انتبهت وأنا طفل لدون كيخوتي وهو بطل سلسلة رسوم متحركة في ثمانينيات القرن الماضي، وتسبب لي في حب للغة الإسبانية لم أبرأ منه إلى اليوم، وكان هذا الحب السبب في أن أحد أساتذتي أهداني في المرحلة الثانوية كتابه العظيم “دون كيخوتي دي لامانشا” فقرأته وأنا لا أفقه كل معانيه، قرأته وفاء للمنزلة التي وضعني فيها أستاذ اللغة الإسبانية حينئذ، وأعجبت أيما إعجاب به، ومن باب هذا الوفاء أجدني مضطرا أن أعرف بحياته، إن هذا الكاتب الألمعي رأى النور في موضع يسمى ألكالا دي إيناريس بمدريد في 1547، وتعني بلغة المتنبي قلعة عبد السلام بمجريط، في فترة كانت الحرب على أشدها بين القوى المسيحية الكاثوليكية والقوى الإسلامية التي يقودها آل عثمان بن أرطغل. وبعد طفولة صاخبة ذهب إلى روما، ثم إلى نابولي حيث ركب هواه فانضم للجيش الإسباني وشارك في المعارك البحرية، ومن بينها معركة “ليبانتو” الشهيرة، فأصيبت يده اليسرى بالشلل حتى أطلق عليه لقب “أكتع ليبانتو” أي صاحب اليد الواحدة وبالإسبانية el manco de Lepanto. وفي عام 1575 ألقي القبض عليه من قبل البحارة الجزائريين ممن يمتهنون الجهاد البحري، ولا يجد المؤرخون الأوروبيون من نعت ينعتونه بهم سوى القراصنة، وهم مجاهدون مقاومون آلوا ألا يتركوا الأساطيل المسيحية تفعل ما تشاء في عرض المتوسط حتى سارت بذكرهم الركبان. ظل سيرفانتس التعيس سنوات في الجزائر بين الأسر ومحاولات الفرار الفاشلة إلى أن جمعت والدته وبعض التجار المتعاطفين معه مبلغ الفدية المتفق عليه، فأطلق سراحه في 1580. وقد قيض لي أن أزور مغارة سيرفانتس في أسفل جبل قبالة الميناء ببلدية بلوزداد وسط الجزائر العاصمة منذ أزيد من عشرين سنة، وكان صاحب الفكرة حينئذ أستاذي مصطفى فيلاح الذي قادني ذات يوم إلى المغارة وأخبرني أن صاحب الدونكيشوت قضى خمس سنوات من حياته بها. أما ما عاناه بعد عودته من فقر وسوء طالع فيستحق بحق أن يكتب عنه روائي من حجمه، فالرجل شغل منصب محصل للضرائب في الحرب الإسبانية وأودع نقوده عند أحد الصيارفة المفلسين، فسجن ثلاث سنوات بسبب العجز في حساباته. وفي عام 1605، استقر ميغيل في بلد الوليـد، فأتم الجزء الأول من رائعته “العبقري النبيل: دون كيخوتي دي لا مانتشا”، وأتم جزأها الثاني بعنوان “العبقري الفارس: دون كيخوتي دي لا مانتشا”.. ونشر كذلك “قصص نموذجية” ورحلة إلى جبل بارناسوس وغيرها.. وقد توفي فقيرا معدما في مدريد سنة 1622. ومن نافل القول عدم استشفاف التأثيرات العربية على هذا الكاتب الكبير، فمؤلف رائعته هو السيد حامد الباذنجاني، ولا غرو أن يثبت سيرفانتيس ظروف صدفة اللقاء بنص (دون كيخوتي) بالعودة إلى فتى يبيع دفاتر وأوراقاً قديمة لتاجر حرير، ليضيف ” وبما أنني أهوى القراءة، وأقرأ حتى أوراق الشارع الممزقة، أخذت مدفوعاً بميولي الطبيعية دفتراً من الدفاتر التي كان يبيعها الفتى، فرأيت أنه مكتوب بحروف عرفت أنها عربية، وبما أنني على الرغم من معرفتي بها لا أعرف قراءتها، رحت أبحث لعلي أعثر على مسلم مستعجم يقرأها، ولم أجد صعوبة بالعثور عليه، … حالفني الحظ، وعبرت لقارئ الأوراق عن رغبتي في معرفة المضامين، ففتح الكتاب من وسطه، وما إن قرأ قليلاً منه حتى انفجر ضاحكا… ثم قال إن العنوان: قصة دون كيخوت دي لامانشا، كتبها سيدي حامد بن علي، المؤرخ العربي ثم ذهبت جانباً مع المسلم إلى رواق الكنيسة، ورجوته أن ينقل من تلك الدفاتر كل ما يتعلق بدون كيخوت إلى اللغة القشتالية دون أن يحذف أو يضيف أي شيء (…) ووعد بأن يترجمها جيداً، بأمانة وبسرعة. (…) حيث ترجمها كلها (…) خلال أكثر من شهر ونصف بقليل”.. لا بد أن سرفانتس احتك بعرب ومسلمين في حياته، سواء من مسلمي الدولة العثمانية والجزائر أو من الموريسكيين، فإن مثل الأولون مناوئين للمسيحية، فإن الآخرين أي الموريسكيين مهادنون أخفوا دينهم ولغتهم وهويتهم، فأين يصنف السيد حامد؟ من الممكن أن ليس من هؤلاء ولا من أولئك..
أما أبو الطيب المتنبي، فهو من ملأ الدنيا وشغل الناس، عاش سبعة قرون قبل ميغيل دي سيرفانتيس، ولم تطأ قدماه غرب البحر المتوسط على الإطلاق، وهو بدون منازع أعظم شعراء العرب، وأكثرهم تمكنًا من اللغة العربية، قبل الإسلام وبعده، ولا زال شعره إلى اليوم مصدر إلهام ووحي للشعراء والأدباء.. قال الشعر صبيًا، فنظم أول أشعاره وعمره تسع سنوات.
وبعد سنين في بادية السماوة أحكم فيها معرفته بلغة الضاد، سار متنقلا حتى حتى حط رحاله في أنطاكية لدى أبي العشائر ابن عم سيف الدولة، ثم اتصل بسيف الدولة ابن حمدان أمير حلب سنة 337 هـ وكانا في سن متقاربة، فوفد عليه المتنبي وعرض عليه أن يمدحه بشعره. وأجازه سيف الدولة على قصائده بالجوائز الكثيرة وقربه إليه فكان من أخلص خلصائه وكان بينهما مودة واحترام، وخاض معه المعارك ضد الروم، ثم حدثت بينه وبين سيف الدولة فجوة قام حساده بجعلها كراهية فغادر حلب وبلاط سيف الدولة. غادر أبو الطيب حلب سنة 346هـ وهو كاره لذلك، فاتّجه في البداية إلى دمشق، ثم شاءت الأقدار أن يذهب إلى مصر حيث استدعاه كافور الإخشيدي، فأقام إلى جوار كافور خمس سنواتٍ مدحه خلالها بعدة قصائد أملاً في تحقيق ما كان يصبو إليه من رفعة وعُلّو شأن، وكان كافور يعرف أنّ المتنبي لم يَكنْ يُضمر له المحبة والود، فلم يحقق شيئاً من أمانيه، بل ضيّق عليه، فكَره الشاعر الإقامة في مصر، وفهجاه هجاء لم ينبس بمثله أحد من العرب ولا العجم وصارت الكافوريات بحق مدرسة في المدح المراد به الذم وأكثر.
شهدت الفترة التي نشأ فيها أبو الطيب تفكك الدولة العباسية وتناثر الدويلات الإسلامية التي قامت على أنقاضها.. فالخلافة في بغداد انحسرت والسلطان الفعلي في أيدي الوزراء وقادة الجيش. وتعرضت الحدود والثغور الإسلامية لغزوات الروم، كما ظهرت حركات سياسية في العراق كحركة القرامطة. وكان لكل وزير ولكل أمير في الكيانات السياسية المتنافسة مجلس يجمع فيه الشعراء يتخذ منهم وسيلة دعاية وتفاخر ووسيلة صلة بينه وبين المجتمع. في هذا الوسط المضطرب كانت نشأة أبي الطيب الذي وعى بذكائه حقيقة ما يجري حوله، فأخذ بأسباب الثقافة وكان طموحه جارفا. وقد أفِلت شمسه وهو في قمة عطائه، فمات في الخمسين من عمره مقتولاً على يد فاتك الأسدي، وهو خال ضبّة الأسدي الذي هجاه المتنبّي في إحدى قصائده، وقد حدث ذلك في طريق عودته من شيراز إلى بغداد، إذ اعترض فاتك طريقه ومعه جماعة من أصحابه أبا الطيب في النعمانية غرب بغداد، فكانت نهايته مقتولا.. وكأنه كان يصف نفسه لا سيف الدولة حين قال:
وقفت وما في الموت شكٌّ لواقف كأنك في جفن الرَّدى وهو نائم
تمر بك الأبطال كَلْمَى هزيمـةً ووجهك وضاحٌ، وثغرُكَ باسم
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قومٍ أنت بالغيب عالم
لئن تساءل متساءل: وما يجمع بين هذين العلمين غير التقاء اسميهما صدفة في بقعة جغرافية بالمغرب الأقصى وهو بلد جامع للعجائب؟ لقلت إن الجامع بينهما هو التناقض، لقد كان المتنبي شاعراً متناقضاً، وكان تناقضه مع نفسه من تناقضه مع عصره، والسبب راجع الى تناقضات عصره والى أفول الدولة العربية، وطموحه اللامحدود الى استعادة بعض الأمجاد الغاربة، فتوالت الانكسارات وأدت الى تخبطه السياسي ومن ثم الى نهايته التراجيدية. أما سيرفانتيس، فلا يقل تناقضا عن الشاعر العربي، فإن كان أول من ابتدع روايات الفروسية فلكونه جرب الجندية وحملته رياح الفروسية في صباه فكان النتيجة انكسارات علم بعدها أن الفروسية ضرب من الأوهام.. واليوم تشاء الصدف أن تجمع العلمين العظيمين في مكان واحد، وأن يمر عليهما المئات والآلاف من المارة دون أن يعيروا اهتماما لهما، فتتوالى الانكسارات ويمر ولا شك حالم من هناك فيصلي من أجلهما قبل أن يبتلعه الشارع الموالي.