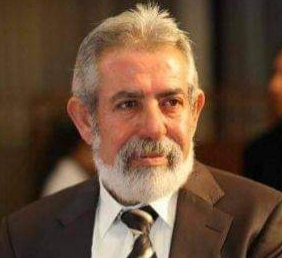معاني القرآن (2)

طاهر العلواني | كاتب مصري
“مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا فلمّا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون”.
هذا ثاني تمثيل في كتاب الله للمنافقين، وإنما عدلتُ عن قولِه سبحانه “فما ربحت تجارتُهم”، من أجل أنَّ هذا يأتيك عند الحديث عن الاستعارة إن شاء الله.
والتمثيلُ ضربٌ من التصوير بديعٌ، له في الفضل شريعةٌ مخصوصةٌ؛ يفرضُ بها للكلام فرضًا من الفصاحةِ، ويجعلُ معها له جُعلًا من البراعةِ، ويُسفرُ عندها عن مخدَّراتِ المعاني؛ كأنَّما عمَدتَ إلى جاريةٍ حسناء، فكسوتَها من صنوفِ الديباجِ، فازداد بحسنِها الديباجُ حسنًا، وازدادتْ ببهائه بهاءً، وهذا معنى ما ذكره الشيخُ أبو عليّ المرزوقيُّ في مقدّمتِه. ومنه أُخذَ التَّمثالُ، وهو الشيء المُصَوَّرُ، وقد كثُرَت في كتابِ الله مواقعُه، وعَزَّتْ في كلامِ الفصحاء؛ من أجل صعوبةِ مسلكِه، وما ترى فيه مِن سحرٍ يجلُّ دقيقُه عن أن يقع في القرائح إذا كان على حد الاعتدال.
و”مثلُهم كمثلِ الذي استوقدَ نارًا”، إنما عبّر بالذي، وهي مفردةٌ؛ مِن حيث كان القصدُ إلى تصوير حالهم في اشترائهم الضلالةَ بالهدى بحالِ المستوقدِ النارَ في المفازةِ ليهتديَ بها، حتى إذا ضاءت واشتعلتْ فأبانت له معالمَ الطريق، ذهب الله بنارِه، كما ذهبَ بنورِ هؤلاء لما استبانت لهم الحُججُ وظهر الأمرُ، ثم لم يكن لهم من دافعٍ مِن أنفسهم إلى الكلمةِ العليا إلا صيانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فمَجُّوا كلمةَ الإيمان مَجًّا من أفواههم لا من قلوبهم، فهذا الذي في تيهاءَ من الأرضِ على تِهواءٍ وقد أخمدَ الله نارَه في حيرتِه وتِيهِهِ بين السِّككِ كهؤلاء في حيرتهم بين الكفر والإيمان؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكأنهم يتذكّرون هذا المثلَ يوم القيامة إذ يقولون للمؤمنين “انظرونا نقتبس من نوركم”. وإنما كانت حالُ المستوقدِ مُنزَّلةً تمامَ التنزُّلِ عليهم؛ من حيث إنَّ نارَه قُدِحتْ مدَّةً، هي كمدّة بقائهم في الدنيا، ثم لما كان على أشدِّ ما يكونُ من الحاجةِ إلى ناره ليستهديَ بها – ومَن كانت له نارٌ ثم خمدتْ أشدّ بؤسًا وحيرةً ممن لا نار له أصلا -، وكان هؤلاء في حاجتهم إلى الإيمانِ كذلك أخمد الله نارَه، كما عادتْ إليه سبحانه كلمةُ النفاق – وكلٌّ إليه راجع -، فلم تك تنفعُهم وقد أخمدها اللهُ في قلوبهم.
ثم تأمل قوله سبحانه “مثلهم”، يعني فيما مرّ من الصفات التي هُم عليها، من انتزاعهم كلمةَ الإيمان من أفواههم عند أهله، وتلقِّيهم الكافرين بكلمة الكفر من قلوبهم، “كمثل الذي استوقد”، فصيغة الاستفعال هنا مبالغة في الإيقاد؛ على حد قولنا: استبان الأمر، وقوله تعالى “فاستجاب لهم ربهم”، ينبئك عنه تنكير “نارًا” الذي يذهب بالكلمة مذهبَ التعظيمِ، كأنّه يحاول استيقادَ النار قدر طاقته، ويسعى في اتّساعها جَهدَه، ثم قال “فلمّا”، التي يقترن جوابها بشرطها، والفاء التي للتعقيب بلا مهلةٍ توحي إليك بقصرِ الحياةِ، ثم قال “أضاءت ما حوله”، أي المستوقدِ، فهي لا تتعدى إلى شيءٍ بعدَه، مقصورةٌ عليه، ثم قال “ذهب الله”، وهو الذي إذا أمسكَ شيئا فلا مرسل له من بعده، وقال “بنورهم”، وهذا مسلك بديع يملؤك روعةً، ويَمسُّك بيانُه فتجدُ لمَسِّه لطفًا وصَبًا؛ فإنَّه خروج عن مقتضى الظاهر، ورجوع إلى المضروب لهم المثلُ على أبهى صورةٍ، وكلُّ خروجٍ عن مقتضى الظاهر تنبيه للسمعِ، وإيقاظٌ للذهنِ، ولو كان الضمير إلى المستوقد لقيل ذهب الله بها؛ لأنها مذكورة عن قريب، أو لقيل بناره بالإفراد؛ لأن المحدَّثَ عنه واحدٌ، ثم ختمها بأعلى ما تسمع من البيان فقال: “وتركهم في ظلمات”، فجيء بالواو، وإن كان هذا إيضاحا لمعنى “ذهب الله بنورهم”؛ إذ كان الغرضُ استعادةَ الأذهان إلى الصورة التي يكونون عليها من التخبط في ظلمة الكفر، وجُعمت الظلمات مبالغة في شدّة الظلمة، ثم قيل “لا يبصرون”، فأُلقي مفعوله؛ لأن القصد إلى تعميم عدم الإبصار، وهو مناسب تماما لقوله بعد ذلك “صم بكم عمي”، فجُعلَ الفعل كأنَّه قاصر لا ينصب مفعولا؛ مثلَ قولِ البحتريّ:
شجو حسّادِه وغيظُ عِداه
أن يرى مبصرٌ ويسمعَ واعِ.
وقولِ عمرو بن معدي كرب:
فلو أنّ قومي أنطقتني رماحهم
نطقتُ، ولكنّ الرماحَ أجَرّتِ.
ثم إنَّ التمثيل لا يكون إلا منتزعًا من صور لا تحصل معها على وجهِ التمثيل إلا إذا امتزجتْ فكانت كأنها صورةٌ واحدةٌ، وأما هنا فإنك تستخرج من كل صورةٍ منها تشبيهًا مفردًا منزّلًا على هؤلاء إذا اقتدحتَ زناد عقلك، فترى أن القرآن مثله كالنور الذي استوقدَه المستوقد في أنَّه هدايةٌ، وهؤلاء كالمستوقد نفسه في أنهم انتفعوا قليلا بكلمة الإيمانِ كما انتفع هذا قليلا بناره ، وعلى هذا قياس سائر الصور في الآية. وهذا من عجائبِها؛ فسبحان مَن تكلَّمَ به وأعجزَ عنه!!
ثم إذا نظرتَ في قول الحماسيّ:
نستوقدُ النَّبْلَ بالحضيضِ ونَصـ**ـطادُ نفوسًا بُنَتْ على الكرمِ.
وجدتَ البيت وإن غمرَك حُسنًا وملأَك نشوةً، جاء بما ليس بمألوف في العقول، ولا يمشي تصديقُه لأحدٍ، وذاك أنَّه جعلَ الحجرَ يشتعل نارًا مبالَغًا فيها عند سفحِ الجبلِ من رميهم السهامَ، وهذه ما لا عينٌ رأتْ. ومبالغاتُ الشعراء من هذا النمطِ كثيرٌ، تأتيك مع كلِّ تشبيهٍ وتمثيلٍ في الكتابِ العريز؛ لتستبين حقيقة الاعتدال والاقتصادِ في معانيه وأصولِه. والله الهادي إلى سواء السبيل.